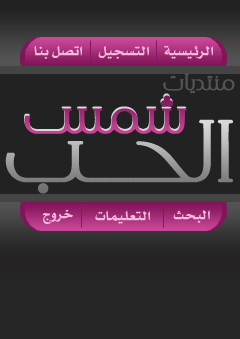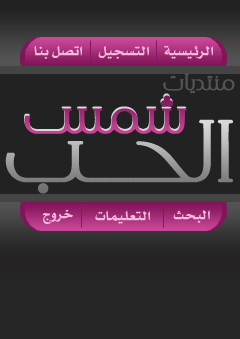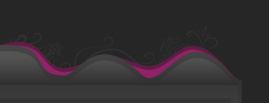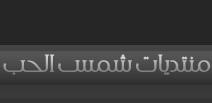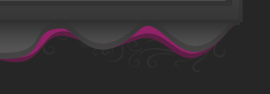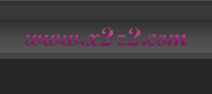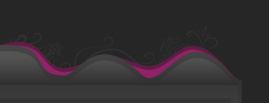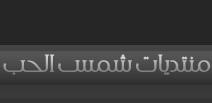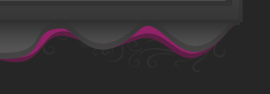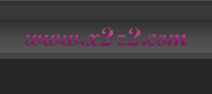[frame="3 80"]صفوان بن صفوان
اللقب شاعر المعتزلة
الميلاد ؟؟
الوفاة 180هـ = 796م
العصر القرن الثاني للهجرة
المنطقة بصرة
المذهب المعتزلة
الاهتمامات الرئيسية الإعتزال - الأدب – الشعر
تأثر بـ واصل بن عطاء - عمرو بن عبيد
تأثر به الجاحظ
هو
صفوان بن
صفوان الأنصاري، أحد أبرز رجال المعتزلة وشعراؤهم في القرن الثاني الهجري. توفي في البصرة حوالي 180 هـ / 796 م. قال عنه المستشرق الفرنسي شارل بلا في كتابه الجاحظ: ((ما تبقى من آثار
صفوان جدير بالدراسة لأنها صدى لفعاليات المعتزلة الأُوَل)). روى عن داود بن يزيد (ت بعد 184 هـ) والي هارون الرشيد على السند. وروى عنه الجاحظ في مواضع عدة من كتبه، فكان يقول: ((أنشدني
صفوان الأنصاري..)). عاصر واصل بن عطاء (ت 131 هـ) ومدحه مراراً في أشعاره وأشاد به كثيراً. ومن أشهر ما قال فيه:
فما مسّ ديناراً ولا صرّ درهماً // ولا عرف الثوب الذي هو قاطعه
يُشيد بزهده، ويقصد بقوله: (الذي هو قاطعه)، الإشارة إلى مهنة واصل وهي غزل الملابس، ولذلك لقب بالغزّال.
و قال فيه أيضاً :
مُلَقَنٌ مُلهَمٌ فيما يُحاولُهُ // جمٌ خواطرهُ جوّابُ آفاقِ
كما عاصر بشار بن برد (ت 167 هـ)، وتصدى لهجوه المعتزلة، ورد عليه في عدة قصائد.
هجاؤه لبشار بن بُرد
قال في بشار وأخَويه بشر وبشير (أحدهما أعرج والآخر ناقص اليد)، وكان يخاطب أمهم :
1- ولدتِ خُلداً وذيخاً في تشتُّمهِ // وبعده خزَراً يشتدّ في الصّعُدِ
2- ثلاثةٌ من ثلاثٍ فُرِّقوا فِرِقاً // فاعرف بذلك عِرقَ الخالِ في الولدِ
الشرح :
الخلد: الجرذ الأعمى، ويقصد به بشار. الذيخ: ذكر الضباع، وهو أعرج، ويقصد به أخو بشار الأول. الخزر: ذكر الأرانب، وهو قصير اليدين، لا يلحقه الكلب في الصعد، ويقصد به أخو بشار الآخر.
تفضيل الأرض على النار ومدح واصل بن عطاء
ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن
صفوان قال :
1- وفي جوفها للعبد أسترُ منزلٍ // وفي ظهرها يقضي فرائضه العبدُ
2- تمجُّ لُفاظ الملح مجّاً وتصطفي // سبائك لا تصدأ وإن قَدُمَ العهدُ
3- وليس بمحصٍ كُنهَ ما في بطونها // حسابٌ ولا خطٌ بُلِغً الجَهدُ
4- فسائِل بعبد الله في يوم حفلِهِ // وذاكَ مقامٌ لا يُشاهدُهُ وغْدُ
5- أقام شبيبٌ وابن صفوانَ قبلَهُ // بقولِ خطيبٍ لا يُجانبهُ القصدُ
6- وقام ابن عيسى ثم قفّاهُ واصلٌ // فأبدع قولاً ما لَهُ في الورى نِدُّ
7- فما نَقَصَتهُ الراءُ إذ كان قادراً // على تَركِها واللفظُ مطردٌ سَرْدُ
8- فَفَضلَ عبد الله خطبة واصلٍ // وضوعف في قَسْم الصلات له الشٌّكدُ
9- فأقنعَ كلَّ القوم شكرُ حِبائِهم // وقلّلّ ذاك الضِّعفُ في عينه الزهدُ
الشرح :
في الأبيات الثلاثة الأولى ذكر لفضل الأرض وإعلاء من شأنها، والغرض من هذا هو الرد على من قال بأفضلية النار على الأرض، وهذه المقارنة بين الأرض والنار صراع فلسفي قديم (الصراع بين الترابية والنارية)، تم تداوله قبل الإسلام، وقد أعيد طرحه في العالم الإسلامي على يد بعض الفرس المتعصبين لثقافتهم الفارسية المجوسية، ومنهم بشار بن برد الذي قال في بيت له:
الأرضُ مظلمةٌ والنار مشرقةٌ // والنار معبودةٌ مذ كانت النارُ
و قد أشار القرآن إلى هذا الصراع بين النار والأرض في قصة آدم وإبليس، حين قال إبليس مبرراً سبب رفضه السجود لآدم : ((خلقتني من نار وخلقته من طين)).. ولعل الممايزة بين المادة والطاقة في العصور الحديثة إمتداد لذاك الصراع، وقد انتهت هذه المجادلة على يد آينشتاين بمعادلته الشهيرة (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء) والتي أثبتت أن المادة والطاقة عبارة عن وجهين لعملة واحدة.
أما الأبيات (4 – 9) فيشير
صفوان فيها إلى ما كان من اجتماع بعض رجالات المعتزلة عند عبد الله بن عبد العزيز والي العراق، وهم: واصل بن عطاء، وخالد بن صفوان، وشبيب، والفضل بن عيسى، حيث يمدحهم ويعرض مواهبهم، ويخص بالمدح واصل بن عطاء، فيذكر بلاغته المتجلية في المقدرة على تجانب حرف الراء الذي كان يلثغ فيه، وفي النهاية يذكر كرم الوالي وتقديمه الأعطيات (الشكد).
و مما يلفت الإنتباه في هذه القصيدة هو الإفتخار بشيخ المعتزلة واصل بن عطاء، وهو فخر مذهبي أو فكري، تفرد المعتزلة به، وفيه خرجوا من تقليدية الفخر العربي القائم على ماضي الأجداد وعراقة النسب.
وصفُ دعاة المعتزلة وعلماؤهم
و ذكر الجاحظ له في البيان والتبيين قصيدة أخرى في الرد على بشار ومدح واصل، وما يميزها هو مدحه ووصفه لدُعاة المعتزلة – الذين كان يرسلهم واصل – وصفاً بلاغياً راقياً، فجاء فيها:
له خلف شًعبِ الصين في كل ثغرةٍ // إلى سوسها الأقصى وخلفَ البرابرِ
رجالٌ دُعاةٌ لا يقلُّ عزيمَهم // تهكّم جبارٍ ولا كيدُ ماكرِ
إذا قال مرّوا في الشتاء تطوعوا // وإن كان صيفٌ لم يُخَفْ شهرُ ناجرِ
بهجرةِ أوطانٍ وبذلٍ وكُلفَةٍ // وشدّةِ أخطارٍ وكدّ المسافرِ
فأنجَحَ مسعاهُم وأثقَبَ زَندَهُم // وأورى بفلجٍ للمخاصمِ قاهرِ
و أوتادُ أرضِ الله في كلّ بلدةٍ // وموضِعُ فُتياها وعلم التشجارِ
و ما كان سحبانٌ يشقُ غُبارَهُم // ولا الشُّدقُ من حيّي هلال بن عامرِ
الشرح:
السوس الأقصى: مدينة في المغرب أما الأدنى ففي الأحواز، الشهر الناجر: هو الشهر شديد الحرارة، علم التشاجر: علم الكلام، سحبان: هو سحبان وائل، خطيب مشهور يضرب فيه المثل.. ثم انتقل إلى مدح واصل بن عطاء وعلماء المعتزلة فقال :
تلقب بالغزّال واحدُ عصره // فمن لليتامى والقبيلِ والمُكاثِرِ
و من لحروريٍ وآخر رافضٌ // وآخرَ مرجي وآخرَ جائرِ
و أمرٍ بمعروفٍ وإنكارِ منكَرٍ // وتحصين دين الله من كل كافرِ
يصيبون فضلَ القولِ في كل موطنٍ // كما طبَقت في العظمِ مُديَةُ جازرِ
تراهم كأن الطيرَ فوق رؤوسهم // على عمةٍ معروفةٍ في المعاشرِ
و سيماهم معروفةٌ في وجوههم // وفي المشي حُجّاجاً وفوق الأباعرِ
و في ركعةٍ تأتي على اليل كلّهِ // وظاهرِ قولٍ في مثالِ الضمائرِ
و في قصّ هُدابٍ وإخفاء شاربٍ // وكورٍ على شيبٍ يضيءُ لناظرِ
الشرح :
الغزّال هو لقب واصل بن عطاء، لقب به لأنه كان يعمل بالغزل والنسيج.
يشير الشاعر هنا إلى الدور المهم الذي أداه المعتزلة في صدر الإسلام المتمثل بالتصدي للمذاهب المنحرفة، مثل الخوارج (الحرورية) والروافض والمرجئة، كما يشير إلى أصل من أصول المعتزلة الخمسة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويختم بذكر إخلاصهم (ظاهر القول يماثل ما في الضمائر) وحسن عبادتهم.[/frame]